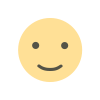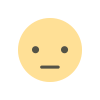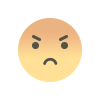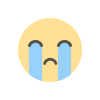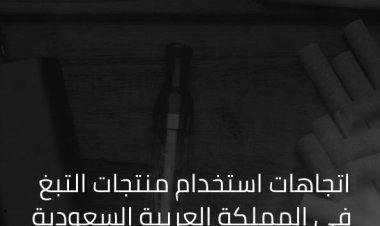ثقافة المظاهر بين البعد النفسي والاجتماعي
في زمن تتسارع فيه الصور وتُجمّل فيه اللحظات للعرض لا للعيش، تتسلل ثقافة المظاهر إلى عمق علاقاتنا، فتُبدد عفويتها وتُصادر صدقها. هذا المقال يتأمل في البعد النفسي والاجتماعي لثقافة التوثيق والاستعراض، ويكشف كيف أصبحت المظاهر عدوًا خفيًا للتجربة الحقيقية والرضا الإنساني العميق.

في الأزمنة القديمة، كان الإنسان يلبس ما يستر، ويبني ما يسكن، ويقول ما يعنيه. اليوم، يلبس ليُرى، ويسكن ليُصوّر، ويقول ليُصفّق له. وبين زمنين، لم يتغير الإنسان في جوهره، لكنه أُغري بالسطح، واستُدرج إلى معركة طويلة مع مرآته: مرآة لا تعكس ملامحه، بل ما يريد أن يقنع به الآخرين.
حين يصير المظهر بديلاً عن الجوهر
ثقافة المظاهر ليست وليدة اللحظة. لكنها في زمن التوثيق المستمر، والعدسات المفتوحة، و"المنصات الشخصية"، تحوّلت من ترف نخبوي إلى قيد جماعي. لم تعد مقتصرة على النخبة التي تسعى للتميّز الاجتماعي، بل أصبحت نمطًا سلوكيًا عامًا، يمارسه الفرد يوميًا من دون وعي، وكأنه لا يعيش، بل "يُعرض".
الفرد الذي يختار مطعمًا لا بناءً على طعمه، بل على ضوءه، وزاوية التصوير فيه؛ الشخص الذي يخطط لرحلة لا ليستمتع بها، بل ليملأ بها شريط القصص اليومية؛ المستخدم الذي لا يشعر بالرضا عن بيته إلا حين يراه مصفوفًا على طريقة المصممين... جميعهم لا يعيشون التجربة بل يوثقونها، ولا يطلبون الحياة بل موافقتها البصرية.
المظاهر كآلية دفاع نفسي
ثقافة المظاهر ليست دومًا طيشًا أو تسطيحًا، بل قد تكون حائط صدّ ضد هشاشة خفية. فحين يشعر الإنسان بعدم الكفاية، يبحث عن أدوات خارجية ترفعه في نظر نفسه أولًا، ثم في عيون الآخرين. التجمّل، التفاخر، الاستعراض... جميعها محاولات للقول: "أنا بخير"، حتى حين يكون الواقع عكس ذلك تمامًا.
ووسائل التواصل الاجتماعي سهّلت هذه الآلية الدفاعية: صورة واحدة تُغطي شعورًا بالوحدة، تعليقٌ براق يُخفي فراغًا داخليًا، متابعة الآلاف تُخدّر الإحساس بالعزلة. كل ما يحتاجه الإنسان ليبدو سعيدًا هو هاتف... أما ليكون سعيدًا فعلًا، فهذا مسار آخر لا تُظهره الصور.
المجتمع كمحفز لهذا السلوك
منذ الطفولة، يتربى الفرد على عبارات من نوع: "وش بيقولون الناس؟"، "ترى الناس تطالع"، "لا تلبس كذا يضحكون عليك". هذه العبارات لا تغرس القيم، بل تغرس الخوف من الحكم الخارجي، وتحول نظرة الآخرين إلى مرجعية دائمة لتقييم الذات.
وحين يكبر هذا الطفل، ويصبح مستخدمًا نشطًا لمنصات التواصل، لا يبحث عن التجربة بل عن "كيف ستُرى"، ولا يقيس نجاحه الشخصي إلا بمرآة الإعجاب. وهكذا يتحول من كائن فاعل إلى كائن عارض، ومن صانع لحياته إلى محررٍ لشريط يومياته بما يرضي جمهورًا لا يعرفه، ولا يعرفه.
أثر ثقافة المظاهر على الرضا والتجربة الحقيقية
المفارقة المؤلمة أن الاستعراض لا يُشبع، بل يزيد الجوع. لأن الرضا شعور داخلي، لا يُولد من الإعجاب، بل من التوافق بين الداخل والخارج، بين ما نعيشه وما نؤمن به. حين يكون كل شيء "من أجل العرض"، تتحول التجربة الحقيقية إلى مجرد محتوى، والمكان الجميل إلى استوديو تصوير، واللحظة العميقة إلى لقطة مؤقتة.
يعيش الإنسان مرهقًا لأنه لا يعيش ذاته، بل نسخة مُفلترة منها، تستهلك منه الطاقة ليُبقيها "لامعة" في أعين الآخرين. وما لا يُقال في هذه الثقافة هو أن من يحاول أن يبدو مثاليًا طوال الوقت، غالبًا ما يعيش شعورًا دائمًا بعدم الكفاية.
حين تُفسد ثقافة المظاهر روابط العلاقات وتُحرّف بوصلتها
في العلاقات، لا يظهر تأثير ثقافة المظاهر فجأة، بل يتسلل بصمت، كما يتسلل الغبار إلى النوافذ المفتوحة... لا يُرى مباشرة، لكنه يغيّر لون الضوء الداخل، ويشوّه الرؤية شيئًا فشيئًا.
حين يبدأ الفرد في تقييم علاقته – بصديقه، أو شريكه، أو حتى أبنائه – لا بما يشعر، بل بما يمكن أن يُعرض، تنحرف العلاقة من كونها رابطة إنسانية إلى كونها مشروعًا استعراضياً. فتُصبح الصور أهم من اللحظات، والهدايا الأغلى من الكلمات، والظهور العلني أهم من التفاهم الخفي.
من يصرّ على أن يُظهر زواجه كنموذج مثالي على الدوام، غالبًا ما يدفن الخلافات تحت السجادة، لا يعالجها. ومن تُشبع حاجته إلى القرب فقط حين يُنشر اسمه في منشور حب، لا في لحظة صمت حقيقية، لا يبحث عن شريك بل عن جمهور.
هذه الثقافة لا تُعطل العلاقات فحسب، بل تقتل عفويتها. لأنها تجعل الإنسان يقيس الحب بمدى قابليته للنشر، ويقيس الصداقة بعدد الصور المعلّقة في ذاكرة الهاتف، لا في ذاكرة القلب.
ثم يأتي التآكل الصامت: حيث تُصبح العلاقة ساحة للمقارنات بدل أن تكون ملاذًا، وتُصبح المطالب شكلية، لأن الجوهر لم يُبْنَ أصلًا. وعندما يُصاب هذا النوع من العلاقات بالفتور أو التفكك، لا يُبكى عليه لأنه حقيقي، بل لأن صورته كانت جميلة.
والأخطر أن هذه الثقافة تُفرغ العلاقات من معانيها الأعمق، لأنها تعوّدنا على مديح العلاقات التي تُرى، لا التي تُعاش.
في النهاية، الحب الذي لا يُصوَّر لا يعني أنه غير موجود، والصداقات التي لا تظهر على "الستوري" لا يعني أنها غير نابضة، والعلاقات الحقيقية لا تحتاج إلى جمهور لتُثبت صدقها، بل إلى مساحات خاصة لا يدخلها إلا المخلصون.
فحين تُصبح العلاقة عرضًا مستمرًا، فإنها تُصبح معرضة للانتهاء في أي لحظة يُغلق فيها الستار.
استعادة الذات من المرايا الزائفة
ليس الحل في محاربة المظاهر، بل في الوعي بها. أن نُدرك أن ما نُظهره ليس دائمًا ما نعيشه، وأن لا بأس أن نحظى بلحظات لا تُصوَّر، بمشاعر لا تُكتب، بتجارب لا تُعرض. الحياة ليست محتوى. والمكان الذي يُشعرك بالراحة ليس مضطرًا ليُعجب الآخرين. والسعادة ليست قابلة للتوثيق، بل للعيش. ربما تكون أجمل اللحظات هي تلك التي لم تُلتقط لها صورة... وربما يكون أجمل إنسان، هو من لا يحاول أن يُثبت ذلك لأحد.